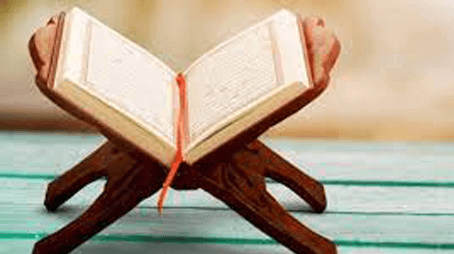
تحدث ابن عاشور في مقدمته الماتعة لتفسيره "التحرير والتنوير" عن عادات القرآن الكريم، وقرر في هذا السياق أن الذي يتصدى لتفسير كتاب الله الكريم عليه أن يتعرف عادات القرآن من نظمه وكلمه، ويعرف اصطلاحه في إطلاق الألفاظ؛ إذ إن للتنزيل المبين اصطلاح وعادات. وألمح في تلك المقدمة إلى أن بعض السلف تعرض لشيء من تلك العادات القرآنية، فرويَ عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: "كل (كأس) في القرآن فالمراد بها الخمر"، وذكر ذلك الطبري عن الضحاك أيضاً. وفي "صحيح البخاري" في تفسير سورة الأنفال، قال ابن عيينة: "ما سمى الله (مطراً) في القرآن إلا عذاباً، وتسميه العرب (الغيث) كما قال تعالى: {وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا} (الشورى:28). وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَ كل ما جاء من {يا أيها الناس} فالمقصود به أهل مكة المشركون.
وقرر الجاحظ في "البيان والتبيين" أن "في القرآن معان لا تكاد تفترق، مثل: الصلاة والزكاة، والجوع والخوف، والجنة والنار، والرغبة والرهبة، والمهاجرين والأنصار، والجن والإنس"، وأضاف ابن عاشور: "والنفع والضر، والسماء والأرض". وذكر الزمخشري والرازي أن من عادة القرآن أنه ما جاء بـ (وعيد) إلا أعقبه بـ (وعد)، وما جاء بـ (نذارة) إلا أعقبها بـ (بشارة)، ويكون ذلك بأسلوب الاستطراد والاعتراض لمناسبة التضاد.
وقد استوعب أبو البقاء الكفوي في كتابه "الكليات" في أوائل أبوابه (كليات) مما ورد في القرآن من معاني الكلمات. وفي "الإتقان في علوم القرآن" لـ السيوطي شيء من ذلك. وتعرض صاحب "الكشاف" إلى شيء من عادات القرآن في متناثر كلامه في "تفسيره".
وفي "الكشاف" عند تفسير قوله تعالى: {فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون * قال قائل منهم إني كان لي قرين} (الصافات:50-51) قال الزمخشري: "جيء به ماضياً على عادة الله في أخباره". وقال الرازي في تفسير قوله تعالى: {يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب} (المائدة:109) قال: "عادة هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعاً كثيرة من الشرائع والتكاليف، أتبعها إما بالإلهيات، وإما بشرح أحوال الأنبياء وأحوال القيامة؛ ليصير ذلك مؤكداً لما تقدم ذكره من التكاليف والشرائع".
هذا، ومن عادات القرآن التي استقرأها ابن عاشور في "تفسيره" الآتي:
- أن كلمة {هؤلاء} في القرآن إذا لم يرد بعدها عطف بيان يبين المشار إليهم، فإنها يراد بها المشركون من أهل مكة، كقوله تعالى: {بل متعت هؤلاء وآباءهم} (الزخرف:29) وقوله سبحانه: {فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين} (الأنعام:89).
- القرآن إذا حكى المحاورات والمجاوبات، حكاها بلفظ {قال} دون حروف عطف، إلا إذا انتقل من محاورة إلى أخرى، كقوله تعالى: {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها} (البقرة:29) إلى قوله: {قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون} (البقرة:33).
- من عادات القرآن أن يذكر أحوال الكفار إغلاظاً عليهم، وتعريضاً بتخويف المسلمين؛ ليُكْرِه إياهم لأحوال أهل الكفر، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: "كل ما جاء في القرآن من ذم أحوال الكفار فمراد منه أيضاً تحذير المسلمين من مثله"؛ ولذلك قال الله تعالى: {ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} (البقرة:275) وقال سبحانه: {والله لا يحب كل كفار أثيم} (البقرة:276).
- عادة القرآن الإعراض عما لا تعلق به بالمقصود؛ فقوله سبحانه: {رب اجعل هذا بلدا آمنا} (البقرة:126) لما جعل (البلد) مفعولاً ثانياً، استغنى عن بيان اسم الإشارة، وقوله تعالى: {رب اجعل هذا البلد آمنا} (إبراهيم:35) لما جعل {آمناً} مفعولاً ثانياً، بيَّن اسم الإشارة بلفظ {البلد} فحصل من مجموع الآيتين أن إبراهيم عليه السلام دعا لبلد بأن يكون آمناً.
- عادة القرآن توجيه الخطاب للنبي ﷺ تحذيراً للأمة من أمر خطير؛ فقوله تعالى: {ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير} (البقرة:120) وقوله سبحانه: {الحق من ربك فلا تكونن من الممترين} (البقرة:147) ونحوهما، المقصود من خطاب النبي ﷺ تحذير الأمة، وهذه عادة القرآن في كل تحذير مهم؛ ليكون خطاب النبي بمثل ذلك -وهو أقرب الخلق إلى الله تعالى وأولاهم بكرامته- دليلاً على أن من وقع في مثل ذلك من الأمة، قد حقت عليه كلمة العذاب.
- من عادة القرآن التفنن من أسلوب إلى أسلوب، وفي انتهاز الفرص في إلقاء التشريع عقب المواعظ وعكسه؛ فقوله سبحانه: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما} (النساء:31) اعتراض ناسب ذكره بعد ذكر ذنبين كبيرين، وهما: قتل النفس، وأكل أموال الناس بالباطل، وهو قوله عز وجل: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم} (النساء:29).
- عادة القرآن في تخلل الأغراض بالموعظة والترغيب والترهيب، وانتهاز فرص تهيؤ القلوب للذكرى، وهي طريقة من الخطابة لتأليف النفوس؛ فقوله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون} (المائدة:35) جاء اعتراض بين آيات وعيد المحاربين وأحكام جزائهم وبين ما بعده من قوله: {إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا} (المائدة:36) خطاباً للمؤمنين بالترغيب بعد أن حذرهم من المفاسد. وقوله سبحانه: {ورحمة للذين آمنوا منكم} (التوبة:61) ترغيب في الإيمان؛ ليكفروا عن سيئاتهم الفارطة، ثم أعقب الترغيب بالترهيب من عواقب إيذاء الرسول بقوله: {والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم} (التوبة:61) وهو إنذار بعذاب الآخرة وعذاب الدنيا. ونحوه قوله سبحانه: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم} (آل عمران:31). وعادة القرآن في الترغيب والترهيب كثيرة في القرآن الكريم.
- ليس من عادة القرآن تحديد المعاني الشرعية وتفاصيلها، ولكنه يؤصِّلها، ويحيل ما وراء ذلك إلى متعارف أهل اللسان من معرفة حقائقها وتمييزها عما يشابهها؛ فالقرآن الكريم لم يفصل القول في حد السرقة، بل اكتفى بتأصيل الحد، وأنه القطع، {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (المائدة:38)، وأحال تفاصيل حدِّ السرقة إلى ما جاء في السنة، وما هو متعارف عليه في لسان العرب، ومثل ذلك يقال في حد القذف والزنى والعبادات المفروضة، وأصول المعاملات.
- جرت عادة القرآن بذكر دلائل الوحدانية في أنفس الناس عقب ذكر دلائلها في الآفاق؛ كما في قوله عز وجل: {وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون} (الأنعام:60) فجمع ذلك في هذه الآية على وجه بديع مؤذن بتعليم صفاته في ضمن دليل وحدانيته، وفي هذا تقريب للبعث بعد الموت.
- عادة القرآن توزيع أغراض القصص على مواقعها؛ ليحصل تجديد الفائدة، وتغيير أسلوب القصص؛ تنشيطاً للسامع، وتفنناً في أساليب الحكاية؛ لأن الغرض الأهم من القصص في القرآن إنما هو العبرة والموعظة والتأسي. كما أن من عادة القرآن الاختصار في سوق القصص؛ اكتفاء بالمقصود من مغزى القصة؛ لئلا يصير القصص مقصداً أصليًّا للتنزيل؛ فقوله عز وجل في قصة أصحاب البستان الذين بيَّتوا النية على قطع ثماره: {ولا يستثنون} (القلم:18) بيَّن أنهم لا يستثنون من ثمار البستان شيئاً للمساكين، وأقسموا ليصرمن جميع الثمر، ولا يتركون منه شيئاً. وهذا التعميم مستفاد مما في (الصرم) من معنى الخَزْنِ والانتفاع بالثمرة، وإلا فإن الصرم لا ينافي إعطاء شيء من المجذوذ لمن يريدون. وأجمل ذلك اعتماداً على ما هو معلوم للسامعين من تفصيل هذه القصة على عادة القرآن في إيجاز حكاية القصص بالاقتصار على موضع العبرة منها. وهذا واضح في قصص الأنبياء التي ساقها القرآن في سور متعددة.
- عادة القرآن في ما إذا ذكر مأمورات يعقبها بالتذكير بحال أمثالها أو بحال أضدادها؛ فقوله سبحانه مخاطباً نساء النبي ﷺ: {ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين} (الأحزاب:31) بعد قوله تعالى في الخطاب نفسه: {لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا} (الأحزاب:32) يثير في نفوس المسلمات أن يسألن: أهن مأجورات على ما يعملن من الحسنات، أو هن مأمورات بمثل ما أُمرت به أزواج النبي ﷺ، أم تلك خصائص لنساء النبي ﷺ، فكان قوله سبحانه: {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات...} (الأحزاب:35) الآية، جواباً لهذا السؤال؛ تذكيراً بأن حال المسلمات والمؤمنات في الحكم المتقدِّم كحال أزواج النبي ﷺ.
- عادة القرآن وضع المسلم بين حالتي: الخوف والرجاء، والأمل والرهبة؛ فقوله عز وجل: {الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير} (فاطر:7) تضمن إشارة إلى طرفين في الضلال والاهتداء، وطوت ما بين ذينك من المراتب؛ ليعلم أن ما بين ذلك ينالهم نصيبهم مَنْ أشبه أحوالهم بأحوال أحد الفريقين على عادة القرآن في وضع المسلم بين الخوف والرجاء، والأمل والرهبة.
- عادة القرآن الترفع عما لا فائدة في تعيينه؛ فقوله عز من قائل: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم} (فاطر:42) أبهم القرآن (الأمة) المرادة {من إحدى الأمم} إذ المقصود أنهم أشهدوا الله على أنهم إن جاءهم رسول، يكونوا أسبق من غيرهم اهتداء، فلم يكن ثمة فائدة بتعيين هذه (الأمة). ومثل ذلك يقال في قصة بقرة بني إسرائيل، وقصة أصحاب الكهف، وقصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، وغير ذلك من الأخبار التي لا فائدة من تعيين الأسماء والزمان والمكان وما شابه ذلك؛ اكتفاء بالمقصود من هذه الأخبار.
- عادة القرآن الإعراض عن وصف رجال من الأمة الإسلامية بمعصية ربهم، إلا عند الاقتضاء لبيان الأحكام؛ بيان ذلك أنه سبحانه وصف مصير أهل الكفر بقوله سبحانه: {وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا...ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين} (الزمر:71) ووصف مصير المتقين بقوله عز شأنه: {وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا...فادخلوها خالدين} (الزمر:73) فلم يذكر سبحانه مصير أهل المعاصي، الذين لم يلتحقوا بالمتقين بالتوبة من الكبائر وغفران الصغائر باجتناب الكبائر؛ فإن الكبائر من أمر الجاهلية، فما كان لأهل الإسلام أن يقعوا فيها، فإذا وقعوا فيها فعليهم بالتوبة، فإذا ماتوا غير تائبين، فإن الله تعالى يحصي لهم حسنات أعمالهم وطيبات نواياهم، فيقاصهم بها إن شاء، ثم هم في ما دون ذلك يقتربون من العقاب بمقدار اقترابهم من حال أهل الكفر في وفرة المعاصي، فيؤمر بهم إلى النار، أو إلى الجنة، ومنهم أهل الأعراف.
- عادة القرآن ترتيب حكاية أحوال الأمم على حسب ترتيبهم في الوجود؛ وهذا واضح في ما ذكره القرآن في سورة الشعراء من خبر قوم إبراهيم، ثم قوم نوح، فـ هود، فـ صالح، فـ لوط، فـ شعيب. ونحو ذلك ما ذكره سبحانه من خبر الأقوام في سور: الأعراف، وهود، والأنبياء، وغيرها من السور.
تلك جملة مقتصدة من (عادات القرآن) أشار إليها بعض المفسرين إشارات عابرة في ثنايا تفاسيرهم، وأصَّلها ابن عاشور في مواضع عديدة من "تفسيره".

 المقالات
المقالات









 الرئيسية
الرئيسية موسوعات
موسوعات مقالات
مقالات الفتوى
الفتوى الاستشارات
الاستشارات الصوتيات
الصوتيات المكتبة
المكتبة المواريث
المواريث بنين وبنات
بنين وبنات